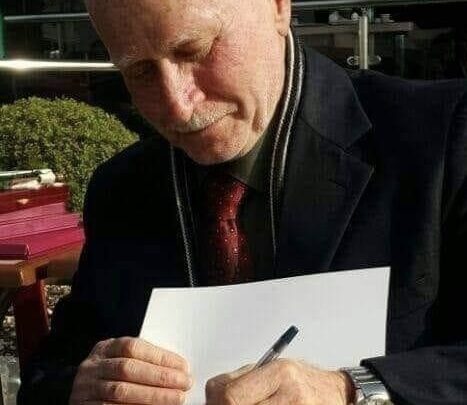
تحرَّك شوقٌ في داخلي للعودةِ إلى البيت، وآخرُ لمزيدٍ من السعيّ؛ فَنَهضْتُ، اتجهتُ نَحْوَ “بيت أصيبعا “مَحْشُوَّ القرون، ثمَّ انعطفتُ إلى نبتةِ “فويلة”/البازيلاء البرية وقطفتُ بعضَ قرونِها على صدى قأقأةِ الحَجَلِ، ومَثَلُ آذارَ يَرِنُّ على مسمعي: (ساعة شمس، وساعة مْطار، وساعة مْقاقاة الشِّنار). انطلقنا شرقا بعد أن استُنْفِذَ ما لدينا في خلة اللوزة؛ وصلنا “خلة القطاط” / “اعْمارة” “الحجة”عزيزة الفرج، فَغَمَرَنا ظلٌ غامقٌ، وأيقظَنا صوتُ طيورِ المساءِ تبغمُ على شجرِ الزيتونِ والتينِ واللوْزِ والخروبِ والشَّعِ والبلوط والجُمِّيز والبُطم؛ شجر العلكة. ومِنْ شجرةٍ لأخرى يَفِرُّ أمامنا السِّمَّنُ، السِّوَّدُ، الخُضَّرُ، أبوزريق، وبقايا الطيور المهاجرة. وفي بطنِ شُجَيْرَةِ سُوِّيد “يتنططُ”عصفورٌ أسودُ، زاهي اللونِ صقيل، طويلُ المِنْقارِ ما عرفْتُهُ، فسألتُ أخي عنه، فقال: هذا عصفورُ الشمسِ الفلسطيني.
انحدرْنا إلى الأسفلِ، ومن أرضِ أبناءِ عارف مصطفى اتجهنا شرقًا إلى خلايل “أبو ريشة”. عبرنا الحقولَ الموشاةَ بألوانِ القمحِ والعدسِ والكِرْسَنَّةِ، فبدت لوحةً يستعصي التعبيرُ عنها، هَجَعَتْ بينَ سَفْحَيْنِ، تهفو مَعَ موجِ نسيمِ المساءِ المتدفقِ شرقًا، وتغفو بسكونٍ وجلالٍ انعقدتْ له الألسنُ الآدميةُ، فما تسمعُ إلا تراتيلَ زِرْعِيَّةٍ على “إمَّاية” بينَ “مارس” وآخر، أو ترانيمَ قبرةٍ ترفرفُ في الفضاءِ المُخْضَوْضِر.
وصلنا الطريقَ الذي يربطُ جلبونَ بالمغير، و كانت شمسُ آذارَ قد غرّبتْ كثيرًا، فتساءلتِ العيونُ، وأجابتْ، بل نمضي في البحثِ، فتجاوَزْنا الطريقَ، وبفتورٍ وارتخاءٍ صَعدْنا شرقًا إلى أطرافِ مراحِ الحطاباتِ الجنوبيِّ، جمعتُ قَبْضةً من الشومرِ البريِّ الشامخ مِنْ “اعْمارة” أبناءِ محمد يوسف حمدان، ومع أول لَمْسةٍ وقضمةٍ فاحَ شذىً منعشٌ، غمرَ الفمَ والأنفاس. وحين استوى المكان في “اعْمارة” الشيخ توفيق محمود أسعد، جددنا العزمَ في بقايا نهار ذلك المساء، فأخذت أطوي مسرعًا أحضانَ السناسلِ وأكوامَ النباتِ النَّجْمِيَّةِ والبلانَ”النتش”رغبةً بالعودةِ بعدَ جولاتٍ من التفتيشِ المضنيةِ التي لم تُثْمِرْ، ودفعًا للمللِ واليأسِ بِفَشْخَةٍ”فَحْجَةٍ” صِبْيانِيَةٍ وصلتُ شجرةَ لَوْزٍ، فبادَرَني أخي، أتريدُ لوزًا؟ وقبلَ أنْ أجيبَ، حرَّكتُ نَبتةَ “تشتِّيلة”، فكانت المفاجأة؛ مدحاة يعلو بيضُها وجهَ الأرضِ، فناديتُ، فجاءَ يتأملُ قُرْصَ البيضِ، وأخذَ يفحصُ سلامتَهُ، ويَعُدُّ: واحدة، اثنتان، عشر، عشرون، أربعٌ وعشرون. وأردفَ قائلا: اشتركَ في المدحاةِ ثلاثُ حَجَلاتٍ كما تقولُ الألوان.
كَسَتْ الفرحةُ قَسَماتِنا، ومَرَحَتْ هي الأخرى نسائمُ المساءِ الأُرْجُوانِيَةِ المشبعةِ بالرطوبة، وتراقصَ شعاعُ الشفقِ الزعفرانيِّ تضامنًا معنا، وقَفَلْنا مبتهجينَ بغُنْمٍ ثمين، فقطَعْنا مراحَ “أبو مسعدة” نهبًا، انحدرنا إلى “اعْمارة” مصطفى المصطفى بخطىً واسعةٍ، تجاوَزْنا “خلة اسْليم” دونَ تَوَقُّف، أدَرْنا ظَهْرَنا لطريقِ “المِغَيِّر”، وسلَكْنا مدخلَ القريةِ الجنوبي، فاستقبلْنا مقامَ “الفقير/الشيخ غثشُم”، وترَكْناهُ على يسارِنا، فقرأنا الفاتحةَ، عَبَرْنا المقبرةَ إلى حاكورتِنا، ومضَيْنا إلى بيْتِنا لتحكي وجوهُنا وعيونُنا ما نحملُ وما نخبئُ .

.png)



