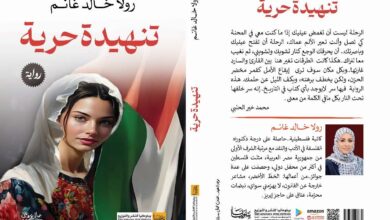لماذا يفشل الأدباء العرب في بلوغ العالمية
من الصعب أن نطالب العالم في الخارج بالاعتراف بأدبائنا وهم الذين فشلوا في أوطانهم في نيل الاعتراف.

لماذا يصعب على أديب تونسي وعربي عموما بلوغ العالمية؟ هل الأمر متعلّق باللغة؟ أم أنّه متعلّق بضعف قدراتنا الإبداعية؟ أم أنّ الأمر يرجع إلى اهتماماتنا الأدبية الغارقة في المحليّة؟ أم أنّ قلّة القرّاء والمهتمين بالجانب الثقافي لتكوين الشخصية بالمقارنة مع الشعوب الأخرى واستهلاك حياتنا في مشاغلنا اليومية هو المانع عن الاحتفاء بالكتاب، ومن ثمّ يفقد الأديب الحافز الأساسي للإبداع، وهو غياب الجمهور المتلقّي المستعدّ لتقبّل أفكاره فتنحسر أعماله ويقلّ تأثيره؟
أعتقد أنّ السبب الرئيسي في عدم بلوغ كتّابنا وشعرائنا العالمية هو أنّ الشعوب الأخرى تبجّل الأدباء وتضعهم على قمّة الهرم في مجتمعاتهم، فرأيهم مسموع وتأثيرهم كبير في صنع الخيارات الوطنية لبلدانهم. إذ يكفي هناك أن تكون كاتبا حتى تخصّص لك الساعات الطويلة في البرامج المتنوّعة والصفحات العريضة في الصحف والمجلّات سواء كانت أدبية أو غيرها، وتفتح لك المؤسسات على اختلاف نشاطاتها، بكل اعتزاز أبوابها من أجل التقاط رؤيتك لبعض القضايا.
وفي الشارع يتوّقف الناس البسطاء للحديث معك ويقفون إجلالا لمكانتك ويسارعون في خدمتك بكلّ حبّ، تقديرا منهم لحافظي الذاكرة وناقلي التجربة الإنسانية. ألم يذكر الكاتب السويدي هنينغ مانكل أنه حين زار المدينة التي عاش فيها طفولته وشبابه “بوروس”، استوقف سيّارة أجرة فتعرّف عليه السائق فأبى أن يأخذ أجرته وظلّ واقفا أمام الفندق الذي يقيم فيه مانكل كل صباح لينتظره وينقله حيث يريد مجّانا، وبرغم اعتراض مانكل وبحثه عن سيّارات أجرة أخرى فإنه اكتشف أنّ جميع السوّاق الرابضين أمام الفندق قد اتّفقوا على نقله مجّانا فلم يجد بدّا من الانصياع إلى رغبة ذلك السائق البسيط.
كان بابلو نيرودا شاعر الشيلي الأول وحين تتمّ برمجة زيارة له إلى إحدى المقاطعات ليلقي قصائده، كان عمّال المناجم الذين لم يجلسوا يوما على مقاعد المدرسة، يفرضون على الشركات التي يعملون بها يوم عطلة من أجل حضور أمسية نيرودا، وحين تكون زيارته مفاجئة ويخطو إلى داخل مصنع للنسيج أو للنحاس، يتوقّف العمّال عن العمل وتتحوّل زيارة النقابي الشاعر إلى أمسية شعرية، يلتقطون ما استطاعوا من ألواح وهياكل معدنية وينصبون له منصّة في أحد المخازن ليستمعوا إلى شعره.
◄ نحن نفتقد لذلك الاقتناع فيبقى تأثير كتّابنا محدودا، لا نرفع لهم القبّعة هنا فكيف يعترف بهم في الخارج وهم الذين فشلوا في أوطانهم في نيل الاعتراف
أعود إلى الأسئلة التي ذكرتها في المقدّمة، هل الأمر متعلّق باللغة؟ طبعا اللغة العربية ليست من اللغات الأكثر مقروئية في العالم رغم كوننا نفوق ما يزيد عن أربعمئة مليون نسمة. الإنجليزية والإسبانية هما اللغتان الأكثر إشعاعا في الأدب، وتتيحان لكلّ أديب جيّد انتشارا واسعا وشهرة عالمية.
ولكن كم عدد القراء الذين يقرؤون باليابانية، أليس هاروكي موراكامي وياسوناري كاواباتا ويكيو ميشيما من أعلام الأدب في العالم؟ كم عدد الناطقين بالبرتغالية، فكيف حظي بيسوا وساراماغو بتلك المكانة؟ والروسية والإيطالية والألمانية والسويدية والنرويجية، أليسوا أقلّ منّا تعدادا؟ كيف تفسّرون ما اكتسبه من منزلة رفيعة كلّ من البوسني إيفو أندريتش، والبلاروسية سفيتلانا ألكسيفيتش والبولونية أولغا توكارتشوك؟ لكم أن تتساءلوا كم عدد الكتّاب الذين يكتبون بالإنجليزية والإسبانية الحاصلين على جائزة نوبل مقارنة بغيرهم الذين يكتبون بلغات أخرى، لن تجدوا فرقا كبيرا.
سوف تقولون أولئك ترجمت أعمالهم ولولا الترجمة لما نالوا اعترافا عالميا، ولكن هل كان لأديب ما انتشار واسع في العالم لم يسبقه اعتراف به في بلده أوّلا؟ ثم لماذا لا تترجم أعمالنا بنفس الطريقة، هل ذلك يعود إلى مستوى إنتاجنا الأدبي الذي لا يشجّع دور النشر العالمية والمترجمين المرموقين إلى نقلها إلى لغات مقروءة عالميا؟ ذلك يقودنا إلى السؤال الثاني في المقدّمة، هل أنّ عدم بلوغنا إلى العالمية متعلّق بضعف قدراتنا الإبداعية؟
قراءاتي الشخصية تنفي ذلك، فعديد من الكتّاب والشعراء التونسيين والعرب عموما، لو تمّت ترجمة أعمالهم إلى الإنجليزية أو الإسبانية أو الفرنسية أو غيرها لكانت تلك الكتب من درر الأدب في العالم. وبعض الأعمال هنا تتفوّق على الكثير من الأعمال العالمية. لو ترجمت أعمالنا لكانت محلّ إشادة من جمهور القرّاء في العالم، لكانت حُوّلت إلى أفلام شهيرة وعرضت في أرقى دور السينما في نيويورك وبرلين وباريس. ولا أخفي أنّ بعض الروايات التونسية والعربية التي قرأتها وجدت فيها متعة وجمالا لم أجدهما في روايات لفائزين بنوبل وهي أشد إتقانا من روايات فائزة بجوائز عالمية مرموقة أرّقتني كثيرا لأستطيع إنهاءها. ألم تفز رواية “سيّدات القمر” للروائية العمانية جوخة الحارثي بالمان البوكر الدولية وهي رواية عادية جدا في نسختها العربية.
يقول البعض إنّ كتّابنا وشعراءنا غارقون في مواضيع لا تتجاوز حدودنا الضيّقة، ولا يهتمّون بقضايا إنسانية جامعة ولا يبحثون في الأسئلة الحارقة التي تطرحها شعوب وحضارات أخرى إلا في ما ندر، تدور أفكارهم وثيمات كتاباتهم حول أحداث ومسائل محليّة لا يجد فيها القارئ غير التونسي أو غير العربي ما يشدّه فيها ولا تعبّر عنه في شيء. هذا قول مقبول نوعا ما ولكن ما هي القضايا التي تختلف جذورها ولا تنبت إلا في بيئة واحدة؟ أليست هموم الناس تقريبا واحدة في كل مكان في العالم، الوجود الإنساني أليس واحدا؟ والطبيعة البشرية أليست نفسها في تونس أو في الأرجنتين أو في الصين؟
متى كانت السياسة والدين والحبّ والجمال والعنف والتفكير في المستقبل خاصّة ببلد واحد فقط؟ أليس سلب الناس حقوقهم فعلا مشينا في كل المجتمعات، والاغتصاب والعنف والاتجار بالبشر والعنصرية دنيئا في كل مكان، والخيانة والخذلان وغياب المشاعر وفقدان الحبّ موجعا لكل شخص على هذه الأرض؟ إذن معالجة قضية ما في تونس هو معالجة لنفس القضية في جوهرها في أي بلد آخر؟
ألم نتعلّم أن النفس البشرية هشّة من دوستيوفسكي قبل أن تكتب روايات تونسية وعربية تصف لنا ذلك؟ ألم ندرك أنّ الحرب والقتل شرّ يهدد كل البشرية عندما قرأنا لتولستوي وسيلين ومندوثا؟ والسجن لدوافع سياسية وقمع المعارضين أرذل ما يمكن لنظام أن يرتكبه في حق الإنسان عندما قرأنا لليسكانو وغاليانو وسبولفيدا قبل أن نقرأ لعبدالرحمان منيف والطاهر بنجلون وعبدالجبار المدوري؟ وأنّ الدكتاتورية هي نفسها بشعة أينما بسطت نفوذها من “مزرعة الحيوان” و”1984″ لأورويل إلى روايات توفيق بن بريك؟
أليس كل من المرأة والرجل كائنين تحيط بكل منهما هواجس العاطفة والخوف من الجنس الآخر والارتباك في كتابات وقصائد سوينكا وهوفمنزثال حتى قصائد نزار قباني وكتابات السعداوي وجنّان؟ وأن الوطن والموت نجدهما في أشعار لوركا وآن سكستون ودرويش ودنقل وأولاد حمد وفي روايات كونديرا وبروست وهانكه وهسه ومحفوظ وخوري وقارة بيبان؟ ومع ذلك، ألم يكرّس جيمس جويس كلّ أدبه لمدينته دبلن ولم يقل أحد عنه أنه يفتقر إلى الإحساس بالعالم ونال شهرة أينما قرأ؟ ألم يكن ناتسوميسوسيكي أديبا يابانيا خالصا فصوّر الريف الياباني والعادات الغابرة ونقلها للجيل المعاصر والتزم بالكتابة عن ذلك فكانت رواياته غاية في الإبداع وشدّ انتباه حتى أولئك القراء الذين لا يعرفون أين تقع اليابان؟
السؤال الأهم هو الأخير وهناك مربط الفرس، أين ذلك التبجيل والاقتناع أن بإمكان الأدب أن يغيّر، وأنّ الكتّاب هم أولئك الذين يقدّم البلد بهم صورة عنه، هم أولئك الذين يحتاج إليهم المعدم للحلم ومسلوب الإرادة للتفكير والذي قست عليه الحياة لزرع الأمل والسياسي للنهوض بالوطن والجاهل للتعلّم والضعيف ليستمدّ القوّة وفاقد الثقة ليستردّ الثقة والحزين لإيجاد الفرح ومكسور الخاطر لجبر روحه.
نحن نفتقد لذلك الاقتناع فيبقى تأثير كتّابنا محدودا، لا نرفع لهم القبّعة هنا فكيف يعترف بهم في الخارج وهم الذين فشلوا في أوطانهم في نيل الاعتراف، نستخفّ بهم فاستخف العالم بهم أيضا، لا نقرأ لهم ولا ندعوهم بالمعلّمين ولا نهتف بأسمائهم ولا نسمّي أبناءنا بأسمائهم ولا نكتشف أنفسنا عبرهم، صغّرنا منهم فصغّرهم المترجمون والنقّاد والجمهور في العالم، إذن كيف لهم أن يبلغوا العالمية؟
في ثلاثينات القرن الماضي حكم على طبيب إيطالي بالإعدام لمشاركته في توزيع منشورات تحريضية ضد النظام الفاشي. زوجة ذلك الطبيب لم تلجأ إلى المحامين ولا إلى السياسيين ولا إلى أصحاب الجاه لإنقاذ زوجها، إلى من تلجأ؟ لقد لجأت إلى كاتب، إلى الأديب النمساوي الكبير ستيفان زفايغ، لقد كان محبوبا في إيطاليا حتى من الدوتشي موسيليني. سافرت إليه والتقت به في منزله في سالسبورغ، وعدها بالمساعدة، أرسل رسالة عاجلة إلى موسيليني، وهل كان موسيليني يستمع إلى أحد؟ طلب منه العفو عن الطبيب وإطلاق سراحه، أجابه موسيليني، “بعظمة ما كتبت يا زفايغ سوف أسمح له بمغادرة التراب الإيطالي”.
◄ اللغة العربية ليست من اللغات الأكثر مقروئية في العالم رغم كوننا نفوق ما يزيد عن أربعمئة مليون نسمة. الإنجليزية والإسبانية هما اللغتان الأكثر إشعاعا في الأدب
كم يقدر الكاتب على فعل أشياء لا يسع لغيره فعلها، لماذا؟ لأنّ تلك الزوجة المتواضعة آمنت به وبقدرته، لأنها تعرف أن للكاتب كلمة مسموعة.
في كتابه الرائع “السيرة الطائرة”، يحدثنا الروائي والشاعر الفلسطيني إبراهيم نصرالله عن زياراته المتعددة إلى عدّة دول، هل انبهر بالبناءات والطرقات، أم بالثروات المكدّسة، أم خفق قلبه من البؤس الذي رآه في بعض القرى والمدن؟ لا لقد أسره حبّ الناس للشعر وللأدب عموما.
في نابولي انتظمت أمسية شعرية في الجامعة، ألقى فيها نصرالله قصائد حول فلسطين بالعربية، الطلّاب الإيطاليون لا يفقهون العربية، ولكن حين أتمّ، تقدم طالب نحو المنصّة، أخذ ورقة وطلب من زملائه المرور الواحد تلو الآخر للإمضاء، بعد ذلك سلّم الورقة إلى نصرالله، ماذا كان في الورقة، لقد كتب ذلك الطالب سلاما حارّا لكل الفلسطينيين.
في ماديين في كولمبيا، المدينة التي يعيش فيها مليونا مواطن، كانت تنظّم فيها أمسيات شعرية في الطرقات والساحات العامّة، تتوقف السيارات، وتغلق الشوارع، وينقطع الفتيان عن مشاهدة كرة القدم رغم عشقهم الكبير لتلك اللعبة، توضع المنصّات، يأتي الشعراء، طوفان بشري يتجمّع، يجلسون على الكراسي والحجارة وعلى التراب، يستمعون إلى الشعر، وعندما ينتهي شاعر من الإلقاء، سواء بلغتهم أو بغيرها، يصفقون، يسارعون نحوه وينحون أمامه، ولا يعود إلى الفندق إلا مرفوعا على الأكتاف.
في ماديين الكولومبية يذكر إبراهيم نصرالله أنّ أمسية شعرية نظّمت في إحدى الضواحي، على ارتفاع 1900 متر عن سطح البحر، الضواحي تلك حيث أشدّ أنواع البؤس قوة في أميركا الجنوبية، أكواخ من قصدير، بشر مكدّسون فوق بعضهم بعضا في مكعّبات يطلق عليها اسم منازل، حيث لا يعرف الأطفال هناك ما معنى حليب أو زبدة، ولا النساء معنى الموضة والكعب العالي، في مدرسة تكاد تسقط جدرانها، لم يستطع الشعراء المرور بين الجمهور، هم فقراء بائسون ولكنّهم يجلّون الكتّاب، حتى أنّ طفلة عمياء اقتربت من نصرالله بعد انتهاء الأمسية وقالت له، لقد رأيتكم، لقد عاد لي بصري عند الاستماع لكم. كيف لمثل تلك الشعوب ألا تدفع دفعا كاتبا نحو العالمية؟ هل بمقدوره أن يبقى غير معروف؟
تلك هي قصّة العالمية في الأدب، فقط أن يكون الكاتب سيّدا عزيزا تكون اللحظات برفقته أثمن من المال والزمن والحياة أيضا، فقط حين ننتبه لذلك، سوف يكون لنا كتّاب عالميون.

.png)