#أبو العلاء المعري .
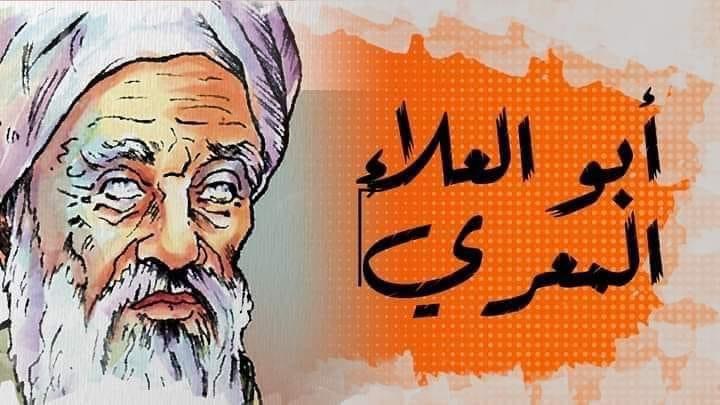
لم أكن أعرف عن #أبي العلاء المعرّي سوى أنّه فحلٌ من فحولِ شعراء العصر العباسي الثانية وأنه لُقِّبَ بالمعري نسبة لمعرة النعمان مسقط رأسه وأنّه متألقٌ في شعره بين شعراء عصره أبجديةً وشمسا، عدا أنّي كنت أحفظ له قليل من الأبيات، لكن بعد دراستي له وجدت في طيات ذاك التألق الشعري خبايا كثيرة خبايا جسدية ونفسية وأدبية..
فنجد أن أبا العلاء المعري قد أُصيبَ بمرضِ الجدري في صغره، وقد اُبتُلي بيتمِ الأبِ وهو في الرابعة عشرة من عمره فما كان من حزنه على أبيه إلا أنه فقد بصر أحد العينين لتتداركها فيما بعد عينه الأخرى، وتلت الراحلين أمّه بعد سنتين من رحيل أبيه، فقد رثاها بقصيدة تفيض لوعةً وحزنًا، يقول فيها: “لا باركَ اللهُ في الدنيا إذا انقطعتْ أسبابُ دنياكِ من أسبابِ دنيانا”.
فبعد ذلك لزم داره معتزلًا الناس مطلقاً على نفسه بـ “رهين المحبسين” إلا أنّه اُخترقت هذه العزلة طلابه من أهل العلم فلم يسلّم كاهله لسلسلة العواصف المُوهنة لم يعيقه فقدان والديه عن طلب العلم ولا عماه أيضًا، فَحمِل آلامه ومضى وأبحر في العلم فرهن نفسَه وحياتَه لطلبِ العلمِ وتعليمه وطموحه نحو النبوغ، فأبوه كان تاركا خلفه ابنًا دارسًا لفنون اللغة والأدب والحديث، قارئا القرآن على جماعة من الشيوخ متلقٍّ علوم النحو واللغة على يد جماعة من اللغويين والنحاة ورحالة لطلب العلم إلى حلب ومن حلب إلى أنطاكية، مما جعله أن يبدل وهنه قوة مُخرجً لنا من سلسلة العواصف سلسلة أعمال شعرية كسقط الزند واللزوميات وأعمال نثرية كرسالة الغفران الشهيرة ومسند أحمد وغيرها من الكتب..
لكن عندما غُصنا في بحورِ أعماله الأدبية وجدنا أن أثر تلك الابتلاءات على أدبه الزاخر وعلى حياته وعلى نفسيته، ففقدان الركنين الأساسيين في حياته أمه وأبيه كفيلة بأن تؤثر به وعليه كأي إنسان ولو بلغ من قوته ما بلغ عدا عن فقدان بصره، فنبدأ باعتزاله الناس أكثر من أربعين سنة إلا أن أهل العلم لم يتركوه للعزلة ألحّوا عليه وطلبوا شرب العلم من منهله فالتزموا داره آمّين له طالبين علمه وأدبه فقد كانوا عارفين لقدره ومنزلته معترفين بفضله ومكانته ولم يقتصر بعزلته فقط عن الناس والمجتمع وإنما أرادها في الآخرة فتمنى ألا يشهد الحشر في الناس، فيقول:
فيا ليتني لا أشهدُ الحشرَ فيهم
إذا بعثوا شعثًا رؤوسهم غبرَا
حتى أنه طلب أن يدفن بموضع لم يحفر فيه قبرٌ لأحد وكأنه يريد أن يرفع فوق قبره راية من الريح ونعرّج على اعتزاله النوعي الذي ألزم نفسه بالحرمان الطوعي، فيقول طه حسين: “لم يدع لنفسه شهوة إلا أذلها ولا عاطفة إلا أخضعها لسلطان العقل”.
نجده في وصفه ارتكز على الأوصاف المعنوية كالحزن والألم والسخط القلق من الحياة والإنسان والنسل والمرأة، وكأنّ مر حكاياته جعلت الخوف والقلق دارجًا على لسانه فسطّر قسوة الحياة وقلقه من خلال حرفه وكلماته، ربما لم يملك عينين ليبكي ابتلاءاته ربما تحجرت آلامه في الأحداق فأخذ يبكيهما في شعره، فلو بحثنا في قاموس الوحدة والعزلة لوجدناه أَلِف كل مفرداتها وتحدّث عنها، فلم يتزوج وطلب من الشباب ألّا يتزوجوا وإن تزوجوا أن يتزوجوا المرأة العقيم وعد النسل ذنبًا لا يغتفر وكان يرى موت البنت خيرا لها من زواجها، وهو يسيء الظن بالمرأة فهي في نظره مصدر كل الشرور عدا أنه سَخطَ على الدنيا وهي في نظره أفرغت الشر على كل ما فيها سواء أكان إنسانا أم حيوان فيقول:
قد فاضت الدنيا بأدناسها
على براياها وأجناسها
وكل حي بها ظالم
وما بها أظلم من ناسها
ألا أننا نتفق معه في نظرته ومهاجمته للنساك المنافقين الذين يتخذون الدين سترا لنفاقهم فيقول:
توهّمت يا مغرور أنّك ديِّنٌ
عليّ يمينُ الله ما لك دينُ
تسيرُ إلى البيتِ الحرام تنسكًا
ويشكوك جارٌ بائسٌ وفقيرُ
أرى أنّه بعزلته وقلقه وخوفه قد جار على نفسه فوق جور الحياة علّه ينسى جور الحياة ويثأر منها لكن دون جدوى، فألزم نفسه قيودًا لا يحتملها إنسانٌ طبيعي فحكم على نفسه أن يبقى في سجونه الأربعة: العمى والبيت والجسد واللزوميات، فسجن الجسد سجن خيالي فلسفي وهو الجسم الذي كره النفس التي تستقر فيه ولا تتجاوز حدوده إلا حين يقضي عليها الموت، ففي شعره كان رهين حبس “اللزوميات” ولزم مالم يلزم، فقد قال في مقدمة اللزونيات: “قد تكلّفت في هذا الكتاب ثلاث كلف: الأولى أنه ينتظم على حروف المعجم، والثانية أن يجيء رويه بالحركات الثلاثة وبالسكون بعد ذلك، والثالثة أنّه لزم مع كل روي فيه شيء لا يلزم من ياء أو تاء أو غير ذلك من الحروف.
فكانت آلامه سلاحًا ذا حدين فإننا نجمع على أنّه أبدع فنًا جديدا أثبت في قدرته على التحدي والقوة والمواجهة عدا أن عزلته كانت مثمرة ومنتجة، فقد ترك لنا تاريخًا عظيمًا من الشعر والأدب والفلسفة، ضل معين لا ينضب للدارسين والباحثين فقد كان يمتلك حافظة ففجّر مواهب عبقريته في ما خلّف من روائع الشعر والنثر خلال عزلته واغترابه عدا أننا نجد الحكمة في طيات ما كتبه فيقول:
تعبٌ كلها الحياة فما أع
جب إلا من راغبٍ في ازديادِ
إنّ حزنا في ساعة الموت أضعاف
سرورٍ في ساعة الميلادِ
خُلقَ الناسُ للبقاء فضلّت
أمةٌ يحسبونهم للنّفادِ
إنما ينقلون من دار أعمال
إلى دار شقوةٍ أو رشادِ
ضجعةُ الموتِ رقدةٌ يستريح
الجسم فيها والعيش مثلُ السهادِ
وفاة ابو العلاء المعري . . .
عاش أبو العلاء المعري شيخوخته وهو ما زال في بيته، فأصاب جسمه الضعف والعجز، وأصبح غير قادرٍ على أداء صلاته قائماً، وقد مرض قبل وفاته بثلاثة أيام عن عمرٍ يناهز الثلاثة والثمانين عاماً، ودفن في المعرّة،وكان قد اجتمع على قبره ثمانون شاعراً يرثونه تعظيماً وتقديراً لدوره في الأدب.وردت روايات عدّة في تاريخ وفاته؛ حيث اتفقت هذه الروايات على أنّ وفاته كانت يوم الجمعة من شهر ربيع الأول للعام 449 للهجرة، بينما اختلفت هذه الروايات في تحديد التاريخ من هذا الشهر؛ فقيل إنّه الثاني وهذا ما ذكره ياقوت، أمّا ابن خلكان فقد جمع بين ثلاثة تواريخ ورجّح أن يكون المعري قد توفي في واحدة منها، وهذه التواريخ هي: الثاني أو الثالث أو الثالث عشرة من شهر ربيع الأول، وأيّده في هذا القول البغدادي، حيث قال إنّه توفي في الثالث عشرة من هذا الشهر، وثبت أنّ التاريخ الصحيح لوفاته كان يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول؛ لأنّ الثالث من هذا الشهر كان يوم السبت، أمّا الثالث عشرة فهو يوم الثلاثاء، وبهذا فإن التاريخ الصحيح لوفاة المعري هو يوم الجمعة الثاني من شهر ربيع الأول للعام 449 للهجرة.
أجمل ما قال أبو العلاء المعري أجمل ما قال أبو العلاء المعري 1 يأتي على الخلق إصباحٌ وإمساءُ 2 الأمرُ أيسر مما أنتَ مضمرُهُ 3 أراني في الثّلاثة من سجوني 4 من لي أن أقيمَ في بلدٍ 5إن غاضَ بحرٌ 6 بينَ الغريزَةِ والرّشادِ نِفارُ 7 اللُّبُّ قُطبٌ ذات صلة ابو العلاء المعري قصائد أجمل قصائد أبي العلاء المعري يأتي على الخلق إصباحٌ وإمساءُ يأتي على الخلقِ إصباحٌ وإمساءُ وكلّنا لصروفِ الدّهرِ نَسّاءُ وكم مضى هَجَريٌّ أو مُشاكلُهُ فيديو قد يعجبك: من المَقاول سَرّوا الناسَ أم ساءوا يموجُ بحركِ والأهواءُ غالبةٌ لراكبيهِ فهل للسُفْنِ إرساءُ إذا تعطّفتِ يوماً كنتِ قاسيةً وإن نظرتِ بعينٍ فهي شَوساء إنسٌ على الأرض تُدمي هامها إحَنٌ منها إذا دَمِيَتْ للوحش أنساءُ فلا تغُرّنْكَ شُمٌّ من جبالهمُ وعِزّةٌ في زمان المُلكِ قعساء نالوا قليلاً من اللذّاتِ وارتحلوا برَغمِهِمْ فإذا النّعماءُ بأساءُ الأمرُ أيسر مما أنتَ مضمرُهُ الأمرُ أيسرُ مما أنتَ مُضمرُهُ فاطرَحْ أذاكَ ويسّرْ كلّ ما صَعُبا ولا يسُرّكَ إن بُلّغْتَهُ أمَلٌ ولا يهمّك غربيبٌ إذا نعبا إنْ جدّ عالمُكَ الأرضيُّ في نبأٍ يغشاهُمُ فتصوّرْ جِدّهُمْ لَعبِا ما الرّأيُ عندكَ في مَلْكٍ تدينُ لهُ مصرٌ أيختارُ دون الرّاحةِ التّعبا لن تستقيمَ أُمورُ النّاس في عُصُر ولا استقامتْ فذا أمناً وذا رعبا ولا يقومُ على حقٍّ بنو زمنٍ من عهد آدمَ كانوا في الهوى شُعَبا أراني في الثّلاثة من سجوني أراني في الثّلاثة من سجوني فلا تسأل عن الخبرِ النّبيثِ لفقدي ناظري ولزومِ بيتي وكونِ النّفس في الجسد الخبيثِ من لي أن أقيمَ في بلدٍ من ليَ أن أقيمَ في بلدٍ أُذكَرُ فيه بغير ما يجبُ يُظَنُّ بيَ اليُسرُ والديانةُ والعلـ ـلمُ وبيني وبينها حُجُبُ كلُّ شهوري عليّ واحدةٌ لا صَفَرٌ يُتّقى ولا رجبُ أقررْتُ بالجهل وادّعى فَهَمي قومٌ فأمري وأمرُهم عجَبُ والحقُّ أني وأنهم هدرٌ لستُ نجيباً ولا همُ نُجُبُ والحالُ ضاقتْ عن ضمِّها جسدي فكيف لي أن يضمّه الشَّجَبُ ما أوسعَ الموت يستريح به الجسـ ـم المعنّى ويخفتُ اللَّجَبُ إن غاضَ بحرٌ إن غاضَ بحرٌ مدّةً فلَطالمَا غَدَرَ الغديرُ فلكٌ يدورُ بحكمَةٍ ولهُ بلا رَيْبٍ مُدِير إنْ مَنّ مالِكُنا بِما نهوَى فمالِكُنا قدير بينَ الغريزَةِ والرّشادِ نِفارُ بينَ الغريزَةِ والرّشادِ نِفارُ وعلى الزّخارِفِ ضُمّتِ الأسفارُ وإذا اقتضيتَ معَ السّعادةِ كابياً أوْريتَهُ ناراً فقيلَ عَفار أمّا زمانُكَ بالأنيسِ فآهِلٌ لكنّهُ ممّا تَودُّ قِفار أقفرتُ منْ جهتينِ: قَفرِ مَعازَةٍ وطعامِ ليلٍ جاءَ وهو قَفار وإذا تَساوى في القبيحِ فعالُنا فمنِ التّقيُّ وأيُّنا الكَفّار والنّاسُ بينَ إقامةٍ وتحمّلٍ وكأنّما أيّامُهمْ أسْفار والحتفُ أنصفَ بينهم لم تمتنعْ منه الرّئالُ ولا نجا الأغفار والذّنبُ ما غُفرانُهُ بتصنّعٍ منّا ولكنْ ربُّنا الغَفّار وكم اشتكتْ أشفارُ عينٍ سُهدَها وشفاؤها ممّا ألمّ شِفار والمرءُ مثلُ اللّيثِ يفرِسُ دائماً ولقدْ يخيبُ وتَظفَرُ الأظفار ولطالما صابرْتُ ليلاً عاتماً فمتى يكونُ الصّبحُ والإسفار يرجو السّلامةَ رَكبُ خَرقٍ متلِفٍ ومن الخَفيرِ أتاهُمُ الإخفار اللُّبُّ قُطبٌ اللُّبُّ قُطبٌ والأمورُ له رَحًى فيهِ تُدَبَّرُ كلُّها وتُدارُ والبدرُ يكمُلُ والمحاقُ مآلُه وكذا الأهِلّةُ عُقْبُها الإبدارُ إلزمْ ذَراكَ وإن لقيتَ خَصَاصةً فاللّيثُ يَستُرُ حالَهُ الإخدار لم تَدرِ ناقةُ صالحٍ لمّا غَدَت أنّ الرّواحَ يُحَمُّ فيه قُدار هذي الشخوص من التّراب كوائِن فالمرءُ لولا أن يُحِسّ جِدار وتَضِنُّ بالشيءِ القليلِ وكلُّ ما تُعطي وتَملِكُ ما له مقدار ويقولُ داري من يقولُ وأعبُدي مَهْ فالعبيدُ لربّنا والدّارَ يا إنسَ كم يَردُ الحياةَ مَعاشرٌ ويكونُ من تلفٍ لهم إصدار أترومُ من زمنٍ وفاءً مُرضياً إنّ الزّمانَ كأهلِه غدّار تقِفونَ والفُلكُ المُسخَّرُ دائرٌ وتقدِّرونَ فتَضحكُالأقدارأبو العلاء المعري متحدي الإعاقة
لقد سجل المعوقون صفحات مشرفة في تاريخ الإنسانية فهناك معوقون صاروا من عظماء الإنسانية ؛ لأن المعوق إنسان عاجز في مكان الإعاقة ، غير أنه طبيعي في النواحي الأخرى ، كما أن بإمكانه استعياب إعاقته وتفعيل إمكانات أخرى ، وتوظيف طاقاته الكامنة ، فيتخطى بعزمه وتصميمه مصاعب الحياة، وقد يفوق كثيرا من الأسوياء .
وعالم المعوقين يعج بالمبدعين ، فالرئيس الواحد والثلاثون للولايات المتحدة الأمريكية “فرانكلين روزفلت(1882ـ 1945) من هؤلاء الذين وقعوا ضحية شلل الأطفال وكان مقعدا تماما . وعبقري الفن “بيتهوفن” أحد هؤلاء المعوقين بعاهته “الصمم”. والشاعر الإغريقي “هوميروس” الضرير قد رسم بملحمتيه الخالدتين الإلياذة والأوديسة صورا من الأساطير الرائعة ، ومن هؤلاء “أبي العلاء المعري” رهين المحبسين ، والدكتور “طه حسين” عميد الأدب العربي ، والشاعر “بشار بن برد” ، و”هيلين كلر”الإنسانة العمياء والبكماء والصماء كانت مثالا يحتذى للإبداع ، كما أن “مركوني” الإيطالي الإنسان الأعور مخترع الراديو لم يقف تعوّقه حائلا حيث حصل على جائزة نوبل عام 19.9م .
وآخر العبقريات الإنسانية صاحبة الإرادة الأوربية “ماري ألين” والتي أصيبت بمرض عضال وهي في العشرين من عمرها ، وأبى المرض إلا أن يصيبها بالشلل الكامل ، ويقعدها على كرسي الإعاقة بشكل دائم إلا أنها على الرغم من كل ذلك ،أبت الاستسلام ، وتوجهت نحو الحياة لتغرف منها وتعيشها بفرح وابتسامة دائمة بما يشبه المعجزة ، حيث أضافت إلي فمها وظائف أخرى غير الأكل والكلام والضحك ، جعلت منه يدا تمسك القلم لتكمل دراستها ، وتحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الإسلامية ، وتمارس كتابة المقالات الأدبية والسياسية في العديد من الصحف والمجلات ، وتمسك الريشة لترسم العشرات من اللوحات الفنية الرائعة التي لفتت الأنظار إليها في المعارض الجماعية التي شاركت فيها ، وتحاول الآن أن تجوب بلوحاتها العالم .
أما العالم “ستيفن هوكيننغ”فيعد من أعظم علماء وعباقرة نهاية القرن العشرين ، ومن أبرز علماء الكونيات الذين تصدروا لأصعب الأسئلة التي تتعلق بخلق الكون ومصيره ، على الرغم من أنه عاجز تماما عن الحركة وعن الكلام من سن 21 حيث أصيب بمرض Amyotrophic lateral sclerosis ويتم اختصاره بـ A L S وهو مرض يصيب الجهاز العصبي الحركي ، ويؤدي بالمريض إلي فقد القدرة على التحكم في عضلاته بالتدريج حين كان يحّضر رسالته في الدكتوراه في الفيزياء النظرية بجامعة كمبريدج . وبعد إعاقته التامة وبإصراره الشديد أصبح من أبرز علماء العالم ، حيث أحتل المناصب العلمية التي كان يحتلها “نيوتن” و”بول ديراك” وكتب عشرات الكتب العلمية الرائعة والتي جعلته من أبرز علماء الكونيات والعالم الأشهر في القرن العشرين بعد أينشتاين”.
(1)
وإذا كان التاريخ الإنساني يفخر بأصحاب إرادات عبقرية وقوى نفسية وروحية تمكنوا بفضلها من الانتصارعلى إعاقاتهم الجسدية ، فإن ابا العلاء المعري (363ـ 449هـ) يعتبر رائدا من رواد متحدي الإعاقة منذ أكثر من عشرة قرون مضت. وإذا كانت مجالات التحدي عند كثير من هؤلاء العباقرة علمية أو تكنولوجية أو موسيقية فنية فإن مجال تحدي أبي العلاء كان في الأدب والشعر واللغة.
وإن ما اجتمع لأبي العلاء المعري من قدرات الفكر والمخيلة ، وغنى التكوين الثقافي ، وقوة الذاكرة ، وحرارة الإحساس بما هو فيه ، مع لذعة الحرمان من نعمة البصر ، منحته كلها قدراته المذهلة على إستيعاب اللغة ، وإحصاء شواردها وشواهدها قريبها وبعيدها ، زمانا ومكانا ، في مجموع تراثها إلى أيامه ، شعرا ونثرا ، حتى كأنه منها ـ وهو الأعمى ـ في كتاب مفتوح ـ ومنحته معها القدرة على خلق عوالم كاملة تؤدي فيها اللغة دور البطولة ، إلى جانب غايات فكرية ونفسية وفرت وقودها أطراف مختلفة من الثقافات ، تستنفد اضطرامه الداخلي ، وحيرته العميقة في فهم ما يقوم من حوله ، أو ما يقال فيه.
الشاعر والفيلسوف : لم يقدر لشاعر عربي ان يحمل لقب الشاعر الفيلسوف ، وإن كان غيره قد سُمي بالشاعر الحكيم أوشاعر الحكمة ، أما الفلسفة فقد ظلت مقصورة عليه بمعناها الواسع والمتعارف : رؤية في الحياة والناس ، ومنهج في إستقراء الظواهر والمواقف ، ووجهة نظر تقلب الأشياء على وجوهها ، ثم ترتد إلى الفكر الكلي الشامل ، تمتح منه المعنى والتفسير والدلالة . هذا هو أبو العلاء المعري فيلسوف المعرة الت يُنسب إليها ، ولطالما سخر من كنيته والناس تدعوه بأبي العلاء ، لكنه كان يرى في نفسه ـ وبشكل ساخر ـ رأيا آخر :
دُعيت “أبا العلاء ” وذاك مين
ولكن الصحيح أبا النزول
والناس مجتمعة على تسميته “برهين المحبسين” : العمى وملازمة داره. أما فقد بصره فقد أصيب به وهو قرب الرابعة من العمر بعد مرض في عينيه أفقده القدرة على الإبصار ، وأما ملازمته الدار فقراره الخاص الذي جعل منه نزيل هذا المحبس فحوالي نصف قرن هي سنوات عمره الأخيرة التي بلغ فيهاالنضج والاكتمال. لكنه في نظر نفسه سجين ثلاثة سجون لا سجنين :
أراني في الثلاثة من سجوني
فلا تسأل عن الخبر النبيث
لفقدي ناظري ، ولزوم بيتي
وكون النفس في الجو الخبيث
والمعري عازف عن الحياة عزوف من عرفها وخبرها وعركها وتأملها ، ببصر نافذ وعقل مشتعل ، وأدت به المعرفة إلى اعتباراها سجنا ، تتحرر منه الروح بفراقها للجسد ، ليعود إليها طهرها ونقاؤها وشفافيتها ، فالجسد نجاسة ، ومسك القول لا يضمخه ولا يرضيه ، لأنه مدرك للحقيقة ، واصل إلى أغوارها ، كاشفا لأسرارها.
المعري وعصره : ويحلل لنا الأديب والشاعر فاروق شوشة في مقال له عن المعري ، هذا العصر الذي عاش فيه وقد عصفت به الصراعات السياسية والثقافية والاجتماعية بقوله: والاجماع منعقد على ان عصر المعري كان عصر فتنة واختلاط واضطراب ، ومن شأن الفتنة أن تعّجل بأطراف
(2)
الرأي وتباعد المذاهب واصطراع الرؤى والأفكار. والفتنة التي قامت باللاذقية ـ بين أتباع أحمد والمسيح ـ كما يقول المعري ، كانت أبعد من هذا وأعمق ، لقد كانت شاملة لمعنى الوجود والحياة ، مزلزلة لمعاني الانتماء وقيم الانتساب ، داعية أمثال المعري من المتأملين والعاكفين والزاهدين إلى الترفع والزهد والنأي بالنفس عن ساحة البغي والخسران.
خذي رأيي ، وحسبك ذاك فني
على ما في من عوج وامت
وماذا يبتغي الجلساء مني
أرادوا منطقي وأردت صمتي ؟
وإذا كنت هذه الروح المتفلسفة المتشائمة هي التي صبغت حياة المعري وفكره وشعره في مرحلة النضج والاكتمال ، وكشفت عنها تجلياته الإبداعية في ديوان “اللزوميات”، فإن ديوانه الأول “سقط الزند” يقدم لنا صورة الفتى الذي يعرف قدر نفسه ، ويضعها حيث ينبغي لها ان تكون ، صونا ورعاية ، وترفعا وإيثارا ، وتقديما وتكريما.
وفي إطار هذا الموقف المؤكد لذات المعري ووعيه بالاختلاف والتمايز والتفرد تجئ قصيدته “ألا في سبيل المجد” يشّرع لنفسه المنهج والسلوك ، والعقيدة والطريقة ، ويصل ما بين الغاية والوسيلة برباط خلقي محكم ، ونسج من مثالياته الخاصة التي تبدو مناقضة لمواضعات عصره وزمانه ، ومجافية لطبع ناسه وإخوانه ، هذه القصيدة التي يبدأها المعري بقوله :
فيا موت زر ؛ إن الحياة ذميمة
ويا نفسي جدي إن دهرك هازل !
إذا اشتاقت الخيل المناهل ، أعرضت
عن الماء ، فأشتاقت إليها المناهل
كأن دجاء الهجر ، والصُبح موعد
بوصل ، وضوء الفجر حب مُماطل
قطعت بحرا ، يعب عبابه
وليس له إلا التبلج ساحل
توقى البدور النقص وهي أهلة
ويدركها النقصان وهي كوامل
ويقدم لنا الأديب فاروق شوشة تحليلا نقديا عميقا لهذه القصيدة فيقول : إن كثيرا من أبيات هذه القصيدة ، بما أتيح لها من إحكام نادر وصياغة رائعة ونفاذ رؤية وعمق تناول ، قد تجاوز فضاءها المحدود سابحا في فضاء الوجود الشعري المطلق ، عندما يتمثل به الناس في حالات مختلفة ، وتستحضرالذاكرة عند الملابسات المماثلة والمواقف العارضة وهو ما سبق للمتنبئ إنجازه في العديد
(3)
من قصائده ، ومن هنا كانت تسميته ـ وقبله تسمية أبي تمام ـ بالشاعر الحكيم. لكن حكمة المعري مغايرة لحكمة المتنبئ ، حين ينتظمها سياق متصل متتابع ، ورؤية متكاملة للوجود ، وموقف صريح من الحياة والموت ، والتزام صارم بما تستلزمه هذه الرؤية ـ الفلسفية ـ من يقين مطلق ، وحسم باتر ، وهو التغاير الذي يفسر المسافة بين الحكيم والفيلسوف ، ويفسر لنا إغراب المعري في تقصّيه للفكرة وإلباسها الثوب المتسق مع يقينه والتزامه ، يقول المعري :
ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا
تجاهلت حتى ظُن أني جاهل
فواعجبا ، كم يدّعي الفضل ناقص
وواسفا ، كم يظُهر النقص فاضل !
وقصيدته التي ذكرناها قصيدة طويلة وأجمل ما أتى فيها قوله :
وقد سار ذكري في البلاد ، فمن لهم
بإخفاء شمس ، ضوءها متكامل
بُهم الليالي بعض ما أن مضمر
ويثقل رضوى دون ما أنا حامل
المتحدي : ومن هنا فليس غريبا أن يتساءل الكاتب حين يقول : هل هو التحدي وحده ـ لشعراء عصره ولكل الشعراء السابقين ـ هو الذي دفع بأبي العلاء المعري إلى إبداع لزومياته ، أو لزوم ما لا يلزم تحقيقا لقوله في شعره :
وإني وإن كنت الأخير زمانه
لأت بما لم تستطعه الأوائل
فأتي بما لم تستطعه الأوائل ، وأيضا بما لم يقدر عليه الأواخر ، الذين حاولوا مجاراته ، فكبوا دون بلوغ مداه ! أم هو ولع المعري بالموسيقى ، ووفرة إحساسه بها ، إيقاعا وتدفقا ، وهو الذي يرى العالم ويحسه بأذنيه ، فجعل كل همه مضاعفة الروي ، بحيث يجيء فيه بالحركات الثلاث ثم بالسكون ملتزما في قوافيه كل حروف المعُجم ! ، أم هي قدرته اللغوية العارمة ، وحافظته المستوعبة الحية ، تسعفه بما لا يستطيعه غيره ، وتفيض عليه بما يتيح له أفقا واسعا من الاختيار ، ونفاذ إلى الكلمة التي تستقر في مكانها غاية الاستقرار وأحكمه ، فتبدوا كالماسة المشّعة في العقد المتلألئ !
إن لزوميات المعري تمثل شعر النضج والحكمة ، والتي تلت شعر الصبا والشباب في ديوانه الأول “سقط الزند” وهي التي تحمل أقباس فلسفته التي تقوم ـ كما يقول الدكتور شوقي ضيف ـ على تشاؤم حاد يُرد إلى فقده لبصره صبيا وإلى ما أطبق على المجتمع لزمنه من شرور ومن حكم فاسد كما تُرد إلى إحساسه العميق بآلام الإنسانية التي ملأت قلبه لوعة ، مما جعله مفكرا إنسانيا عظيما ، بالإضافة إلى جانب ثان استمده من الدين الحنيف وما فيه من دعوة إلى الزهد والتقشف والإيمان
(4)
الصادق بالله وملائكته وكتبه وتكاليفه الشرعية واليوم الآخر . وما فيه من ثواب وعقاب ، مع الاعتقاد بحدوث الكون وكل ما فيه من مادة وزمان وأفلاك وكواكب ، فالله خالق الكون ومبدعه قال له : كن فكان. وجانب ثالث في فلسفته استمده من الاعتزال وما فيه من تمجيد العقل وتقديسه ، ومن وجوب العدل على الله وتنزيهه عن التجسيد ، ومن الإيمان بحرية الإرادة للإنسان ، وأنه حر كامل الحرية في أفعاله الشريرة الآثمة والخيرة الطيبة”. وهو الجانب الذي ذهب فيه المعري مذهب المعتزلة أصحاب أكبر حركة عقلية في تاريخ الإسلام !
المعري وأسئلة كاشفة : سؤال لابد أن يواجه من ينظر في الكتب والرسائل التي أملاها أبو العلاء ، في عزلته الطويلة ، في بيته الذي دُفن فيه ، في حلب ، هل كان يبني أعماله الإبداعية من مفردات اللغة : ينفث فيها من روحه ، وينطقها بلسانه ، أو يُلغز فيها ، ويصلها بالقرآن الكريم ،أو الحديث الشريف ، أو الحديث المأثور ، أو الشعر العربي منذ أنشده أصحابه في جزيرة العرب ، وفي ديارهم كافة إلى عصره ، أو يصلها بالتاريخ ورجاله ، أو ببعض الثقافات الأخرى ، أو يديرها على محاورها الدلالية فيستنطقها مقطّعة حينا ، وموصولة حينا ، في سياق الأحداث ، والمواقف ، والحوارات ـ على ما يذكر الكاتب عبد الكريم الأشتر في مقاله عن “المعري واللغة” ـ التي يصوغها خياله الحر ، على الأرض ، في عالمنا الذي نحن فيه ، أو في العالم الآخر الذي تتبع أخباره ، وصوره ، في تراثنا الديني.
والسؤال هو : ما الغرض الذي كان أبوالعلاء في هذا المعترك اللغوي الحافل ، يسعى إليه ؟ هل كان يرمي إلى تعليم اللغة ، أم كان يرمي إلى كتابة أثر إبداعي يستنفد فيه قدرات خياله المشبوب في عتمة العالم من حوله والتعبير عن حقائقه الكبرى ، على نحو ما كان يراها ، أو حقائق النفس البشري أو ينّفس فيها عن كربه الذي يعيش فيه ، أو يلجأ إلى اللعب الفني باللغة ، يقطع به ملل عزلته الطويلة ، أم لعله كان يريد ان يعوّض عن إحساسه بالنقص ، فيذّكر المبصرين من حوله بقدراته اللغوية والفكرية الرائعة التي ترفعه عنهم درجات ؟
في تراث أبي العلاء الذي خلّفه ما نستطيع أن ننتهي معه إلى القول : إن أبا العلاء كان يرمي إلى هذا كله ، ولكن جوهر السؤال يظل يقف عند الغرض التعليمي ، والغرض الإبداعي . هل كان يسّخر اللغة على النحو الذي وصفناه لغرض التعليمي أم كان يسخرها لغرض إبداعي وفاء بما كان يرمي إلى التعبير عنه ، ليستفيد به إحساسه بالحياة ، وبنفسه ، وبالناس والأشياء من حوله ؟ ثم أي الغرضين جعله سبيلا إلى الآخر : هل ساقه تعليم اللغة إلى خلق عوالمه الإبداعية ، أم جعل من خلق الأثر الإبداعي سبيلا إلى تعليم اللغة ؟ وينبني على هذا ونحن نقرأ آثار المعري التي نقف عليها هنا ان علينا ان نولي اهتمامنا سعة الأفق التي جالت فيه ، أو نولّيه جوانب الجمال في عوالمه الإبداعية.
ولذلك ينتهي تحليل الكاتب عبدالكريم الأشتر ـ وهو في هذا متسق مع نصوص المعري الموجودة ـ على أن السعي إلى الجمع بين الغرضين معا ، على المدى الواسع ، الذي تحفظه آثار أبي العلاء يفرده في تاريخنا من بين أعلام اللغويين ؛ ذلك ان الغرضين ينتسبان ـ في ميدان النشاط الفكري ـ إلى حقلين مختلفين : حقل يعتمد العمل فيه على القياس ، ويلتزم الموضوعية ، ويتجه إلى الكشف عن منطق اللغة في توزيع أصواتها ، وبناء وحداتها ، وصياغة جملها وتراكيبها منها ، وإحصاء الأشباه والنظائر في أوزان ألفاظها ، ودرس العلائق بينها ، وحقل يشغل صاحبه بعملية الخلق الفني وما يلزمها من قوة المخيلة ، وقدرة التحرر من ضوابط العقل القائمة في الحياة من حوله ، لبناء عالم خاص ، له مرجعه الخاص ، ومنطقه الخاص ، وظروفه الخاصة ، ومن ثم لغته وصوره وجمالياته الخاصة.
(5)
ولذلك يؤكد الباحث على هذا المعنى بقوله :”ولست أعرف ندا لأبي العلاء في تاريخ لغتنا وأدبها ، سخّر اللغة لهذين الغرضين معا: التعليمي والإبداعي ، حتى ليصعب ـ أحيانا ـ ان نحدد ـ على وجه اليقين ـ أي الغرضين كان وسيلة للغرض الآخر ، أعني : أيهما كان الوسيلة ، وأيهما هو الغاية ؟
وقد يعترض مُعترض ويتمثل بالهمذاني بديع الزمان ، كاتب المقامات (ت 398هـ) ، فقد كتبها لقصد تعليمي سخّر له تقنيات سردية اعتمد لها ـ مثل المعري (هما في عصر واحد:القرن الهجري الرابع) فواصل مسجوعة تعين عل حفظها . ولكنه وزعها على مجموعة من الحكايات القصيرة ، يتضح فيها الغرض التعليمي اتضاحا يغني عن طلب التحديد ، إنه لم يخلق عالما فكريا موحدا يستغرقه كتاب بتمامه ، تدور وقائعه كلها فيه . ثم إن النزوع اللغوي فيها ، من ناحية أخرى ، لم يبلغ ما بلغه في آثار المعري من العمق ، والسعة ، وترامي الأطراف.
حبيس سجون ثلاثة : ولد المعري في عام 363هـ في معرة النعمان من أعمال حمص بين حلب وحماة إليها ينسب ، مشتهرا بكنية “أبي العلاء” وفقد بصره صغيرا في مرض الجدري ،وكان يقول :” لا أعرف من الألوان إلا اللون الأحمر، لأني ألبست في الجدري ثوبا مصبوغا بالعصفر، لا أعقل غير ذلك “. ونشأ في بيت قضاء وعلم وشعر، بادئا بحفظ القرآن الكريم ، وحين قرر ألا يغادر داره بعد أن بلغ السابعة والثلاثين حتى وفاته عن ستة وثمانين عاما ، أطلق عليه رهين المحبسين ، لكنه عد نفسه نزيلا لثلاثة سجون حين قال :
أراني في الثلاثة من سجوني
فلا تسأل عن الخبر النبيث
لفقدي ناظري ولزوم بيتي
وكون النفس في الجسم الخبيث
والخبر النبيث هو الخفي ، إذن فهو سجين العمى ، وسجين الدار التي لم يعد يفارقها ، وسجين الجسم الذي لن يتحرر منه إلا بالموت ، ففي الموت حريته وتحرره ، وعلى امتداد قرابة نصف قرن من لزومه لبيته أنجز المعري أعماله الكبرى : اللزوميات ورسالة الغفران وكتاب الصاهل والشاحج ـ متحدثا فيه على لسان فرس وبغل ـ وكتاب القائف ـ وهو أمثال على طريقة كليلة ودمنة ـ وكتاب الفصول والغايات ، وديوانه الصغير “الدرعيات” وغيرها.
في لزوميات المعري أو ديوانه “لزوم مالا يلزم” بصر نافذ في الحياة والإنسان والمجتمع والكون ، ووقوع على الشرور الكبرى والصغرى بدءا بشرور الحكم الفاسد إلى آلام الإنسان وأوجاعه في دنياه مؤمنا بالعقل الذي يتخذه إماما له لا يثق إلا به ولا يلقى مقاليده إلا إليه :
كذب الظن لا إمام سوى العقل
مشيرا في صبحه والمساء
اللزوميات إذن هي صوت المعري الحقيقي في شعره ، صوته الرافض للفساد والظلم والطغيان والجبروت ، صوته الهادر بالحزن والسخرية والمرارة والتشاؤم ، صوت المُعلّى للكرامة الإنسانية واليقين العقلي والحرية الإنسانية ، يرفعه في زمن لا يختلف كثيرا عن زمننا الذي نعيشه ، فسادا وتشرذما ومذلة وهوانا ، ونزاعات وخصومات ، وتشبثا بالباطل ، وانحباسا داخل صغائر الأمور وظلمات الجهالة الجهلاء.
(6)
وهو يشرح كل ذلك ويحلله في لزومياته بدقة بالغة وببصيرة نافذة وينتهي في إحدى قصائده إلى التحذير والانتباه من فتنة هؤلاء المفسدين حين يقول :
أفيقوا افيقوا ياغواة ، فإنما
دياناتكم مكر من القدماء
أرادوا بها جمع الحطام فأدركوا
وبادوا وماتت سنة اللؤماء
يقولون إن الدهر قد جاء موته
ولم يبق في الأيام غير دماء
وقد كذبوا ما يعرفون انقضاءه
فلا تسمعوا من كاذب الزعماء
وكيف أقضى ساعة بمسرة
وأعلم ان الموت من غُرمائي
خذوا وحذرا من أقربين وجانب
ولا تذهلوا عن سيرة الحزماء
ولا شك أن من يقرأ تراث أبي العلاء في النثر والشعر معا ، يدرك مساحة إحساسه بفقد حاسة البصر ، ومكان سعيه إلى التعويض عنها بإرهافه حاسة السمع ، وتذوق الأصوات ، ودقة التمييز بينها . ثم إن الصمت في سواد الليل وسّجوه وامتداده في داخله ، تجعله أقدر على التقاطها وجمعها حتى ليمثّل الأقدار بعض الناس وتفوقها على غيرها بفضل بحر الشعر بعضها على بعض ، مثل “الطويل على المنهوك” في رسالة ” الصاهل” ويمثل للنقص في طاغية الروم عن طريق العروض أيضا، ويجمع أمور وأحوال بطارقتهم ، وأمور العروض في بعض تعقيباته ، في تقصيب واحد جامع ، ويفيد من مصطلح العروض في تمثيله لحال هجوم الروم وأحوال الناس فيه ، ويستعين بالقافية في تمثيله للمتصدين للعدوان وضربه على أقفيته ، وفي هذا وفي غيره ، من مكان الموسيقا ، على الإجمال ، من حياته ونتاجه ، كلام كثير يصلح ان يفرد له بحث خاص ، يمس جانب الإبداع فيهما.
المعري فلكيا : لقد كان أبو العلاء المعري شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء ، وأحد أكبر الشعراء العرب وأعمقهم ثقافة وأرسخهم قدما في علوم العربية والمنطق والفلسفة ، وأحد القلائل الذين لهم خبرة بالنفس الإنسانية وتقلباتها. ويزيد إعجابنا بسعة ثقافته إذا تقصينا شيئا من ثقافته الفلكية.
ولا شك أنه يبهر أبوالعلاء المعري من له دراية بالفلك ، ويحار في الدقة التي يصف بها الشاعر المجموعات النجمية وطلوعها وشروقها الواحدة تلو الأخرى ، وهو الضرير الذي حُرم من متعة النظر إلى السماء. ولقد أكثر المعري من ذكر النجوم والكواكب ، ولا جرم أنه كان يعّظم شأنها هو القائل عن زحل :
(7)
رحل أشرف الكواكب دارا
من القاء الردي على ميعاد
والمعري كغيره من المثقفين في العصر العباسي الأول والثاني الذين اطلعوا ولا ريب على مؤلفات أفلاطون وأرسطو وبطليموس . والإشارة هنا بقوله” أشرف الكواكب دارا” إلى كون زحل الكوكب الأبعد مدارا ، حول الأرض لا حول الشمس ، لأن النظرية البطليموسية وفحواها ان (الأرض مركز الكون) سادت حتى عصر كوبرنيكوس ، ولهذا وقف الإنسان القديم الذي نعرفه عن الكواكب عند زحل لأن الكواكب الأخرى (أورانوس ونبتون وبلوتو) لا تُرى إلا بالمناظير القوية.
وقد كان المعري مؤمنا بفناء المادة وانحلال الكون من حيث هو نجوم وكواكب . وقد تحدث المعري عن”اقتران الكواكب” وفي لزومياته إشارات فلكية تخفى على كثير من المثقفين في عصره وفي غيره من العصور ، كإشارته إلى اقتران الكواكب ، وهو من الناحية الفلكية اجتماع كوكبين أو أكثر في برج من البروج في أقرب مساحة ممكنة ، وإذا علمنا أن بعض الكواكب لا تتم دورة واحدة حول الشمس إلا خلال عشرات السنين اتضح لنا أن هذا الأمر نادر الحدوث .
ومن الاقترانات التي تناولها المعري ما تعلق بكوكب المشتري وزحل وقد كان القدماء يتفاءلون خيرا بهذا الاقتران ، على عكس من تشاؤمهم بظهور المذنبات يقول المعري :
قرآن المشترى زحلا يُرجي
لإيقاظ النواظر من كراها
وفي قصيدة “عللّاني” ، وهي قصيدة نظمها الشاعر في عهد الشباب حاول فيها ان يحاكي المبصرين في دقة الوصف ، متعاليا على عاهته ، وقد نجح في ذلك إلى حد الإعجاز. وقد ولع المعري بذكر نجم”سُهيل” وهو نجم عملاق أحمر يبعد عن الأرض بحوالي 4.. سنة ضوئية ، وهو جد مهم في الملاحة الفضائية لأنه يُستخدم كنقطة مرجعية في توجيه السفن الفضائية في رحلاتها بين الكواكب.
وفي آخر القصيدة يختتمها المعري بالإشارة إلي شروق كوكبة “النسر الواقع” وفيها النجم اللامع “Ve Ga ” وهي كوكبة تشرق في أواخر الربيع قبل الفجر ثم تتقدم غرب السماء يوم بعد يوم ، وبالتالي تكون محتلة للسمت في فصل الصيف ، والعارف بالفلك يحار في دقة المعري في تقصي هذه المجموعات النجمية وهو الضرير ، كما أن من النجوم التي ذكرها في لزومياته وسائر شعره : الشعرى اليمانية والشعرى الشامية .
وفي قصيدة المعري المشهورة”الآ في سبيل المجد” وهي التي نظمها في عهد الشباب وافتخر فيها بمركزه الأدبي وأخلاقه العالية يذكر نجما هو”السُها” ، وهو نجم خفي في كوكبة الدب الأكبر في الذيل ، كانت العرب تمتحن به قوة البصر عندهم ، وقالت في المثل” أريها ألسُها وترني القمر” وهو مثل يُضرب للشخص تريه الأمر الخفي ، فيضرب عنه صفحا ويتحدث عن الواضح الجلي ، يقول المعري مشيرا إلى هذا النجم :
وقالت السُها للشمس أنت خفية
وقال الدجُى يا صبح لونك حائل
(8)
وهو يشير من خلال ذكر هذا النجم الكبير إلى فساد القيم وانقلاب الأوضاع ، إلى درجة ان الحقير الصغير يطاول الشريف الكبير . وكما ذكر المعري الكواكب وأولع بذكر المريخ وزحل ، وذكر النجوم البعيدة ، وجدناه في لزومياته يتردد ذكر الفراقد أو الفرقدين ، ولم يغفل الإشارة إلى السّماكين وهما نجمان عملاقان هما”السمّاك الرامح” و”السّماك الأعزل” ، أما الشمس نجمنا الذي يبدد سواد الفضاء ووحشة الكون فقد شغل هذا النجم عقل المعري الجبار وتساءل عن زمن مولد هذي الشمس وأدرك أنه قديم :
ومولد هذ الشمس أعياك خبره
وخبر لب أنه متقادم
واستأثر الزمن بفكر الشاعر الفيلسوف كما استأثر بعقول فلاسفة الإغريق وبعقل نيوتن وأينشتين من بعد ، وإن كانت نظرية النسبية قد فصّلت في نسبية الفضاء والزمن ، فالمعري يرى ان تيار الزمن ينساب في الكون ويملؤه ولا توجد نقطة في الكون بلا زمن .
المعري وإبداعاته اللغوية : ويبدو أن حب أبي العلاء للغة واهتمامه بعلومها جملة ، دفعاه إلى تنويع الأساليب في تعليمها بما قّوّى خياله ، وحّفزه إلى أن يسلك به مسالك مختلفة حققت له صفة الإبداع الفني ، إذا توافرت فيه الجدة والابتكار ، وشروط الإثارة الجمالية ، وتماسك المواقف ، وطرافتها وغنى الصورة ورهافة اللغة ، وغنى دلالاتها ، وقوة الصلة بالحياة ومعاييرها وقضاياها الكبرى ، فوق عمق الشعور وألوان الثقافات التي يمتح منها.
ومن روائع ابداعه في أعماله السابقة نجده يصعد بقارئه إلى العالم الآخر ، حيث يستدعي له فيه كبار اللغويين وجلة الشعراء ، فحاورهم في إشكالات شعرهم التي وعاها ، وعرض كثيرا من آرائه في اللغة وعلومها. وهكذا ساق الكلام على لسان الملائكة وخزنة الفردوس والنار ، وعلى شخوص تخيلهم من الجن ، فساءلهم في قضاياهم وأوزانها. ووضع الكلام على لسان الحية والحمامة ، والعصفور ، والأسد ، والفأر، والحصان ، والبغل ، والجمل ، والثعلب ، والضبع ، في رسائله وكتبه الأخرى التي غابت عنا (مثل رسالة القائف ، وكتاب سجع الحمائم) إلى جانب ما وصل إلينا من رسائله التي ذكرناها.
ولكن أبا العلاء ، حقق لنفسه ، في آثاره الإبداعية ، أغراضا أخرى : شكا دهره وزمنه وناسه ، وهجا الإنسان على إطلاقه ، ونّفس عن همه في عزلته الطويلة ، واستعلى بثقافته وسعة معرفته وحفظه ، على من كتب إليه. وعرّض بما لم يستطع قبوله أو تصديقه من الأخبار والروايات على إطلاقها أيضا.
وعرض لكثير من أحداث عصره ، ووقف إلى جانب قومه فيها(توقع غزو الروم ، وموقفه منهم ومن”طاغيتهم” على حد وصفه) ، وتسلى بطرائف خطرت له تشي بقدرته على التطريف حين يفّرع له ، وتسوقه إليه خطرات خياله ، مثل كلامه على(أزواج الإوز) في العالم الآخر ، وشفاعة السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، واجتياز ابن القارح الصراط محمولا على صورة (الزقفونة) وتفتح الثمار عن الجواري والغواني ، وإعادة خلقهم على ما يشتهي.
ومثله غير قليل في أنحاء رسالة (الغفران) : مجالس الغناء في الفردوس وأنهار الفقاع الجارية ، والطاووس المصوص ، والإوزة المطبوخة ، وقد اجتمعت أعضاؤها وعادت إلى الحياة ، وتغير خلق الجواري، وجنة العفاريت وأشعارها، وترشف رضاب الكواعب الأتراب ، وتحويله الشعر إلى مساكن في الجنة.
(9)
لقد تجلت عبقرية إبداع المعري في كثير من إنتاجه الأدبي عامة والشعري خاصة ، ولذلك نجد في تراثه من حرارة الروح ، ورهافة الإحساس ، وغنى النفس ، ما تلمسه في قدراته الوصفية التي تتجلى فيها جماليات الأمكنة التي تعرض لوصفها في العالم الآخر ، على مثال وصفه لسحاب الجنة :” ينشئ الله ـ تعالى آلاؤه ـ سحابة كأحسن ما يكون من السحاب ـ ومن نظر إليها شهد انه لم ير قط شيئا أحسن منها ، محلاة بالبرق في وسطها وأطرافها ، تمطر بماء ورد الجنة من طلل وطش ، وتنثر حصى الكافور كأنه صغار البرد ، فعز إلهنا القدير الذي لا يعجزه تصوير الأماني ، وتكوين الهواجس من الظنون”.
ووصفه جنة العفاريت :”فيركب بعض دواب الجنة ، ويسير ، فإذا هو بمدائن ليست كمدائن الجنة ، ولا عليها النور الشعشعاني ، وهي ذات أوحال وغجاليل ” كذلك وصفه لساحات الجنة ودوابها ، “فيركب نجيبا من نُجب الجنة ، خُلق من ياقوت ودّر ، في سجسج ، بُعد عن الحر والقر ، ومعه إناء فيهج (الخمر) ، فيسير في الجنة ، على غير منهج ، ومعه شيء من طعام الخلود”.
وهكذا ، نجد المعري ، يحفّزه تعلم اللغة ، فيطلق خياله في خلق عوالم ، وأحداث ، ومواقف وشخوص ، وحيوان، يضع على ألسنتها أحاديث وردود أو حوارات تدور كلها من حول اللغة وإشكالاتها ، وشواهدها وشروحها ، وتنقل آراءه في رواياتها ، وتتيح له هذه العولمة المبتدعة بدورها ، من تصوير شاهدها ، ومجرياتها ، وحواراتها ، وأحداثها المقطورة فرصا أخرى لعرض محفوظة الجميل المثير الكثير من الشعر ، وما تثير رواياته ولغته من إشكالات تستجر بدورها إشكالات أخرى ، وتتيح فرصا أخرى لتعليم اللغة ومذاهب رجالها.
وهو من خلال ذلك كله ، يعرض آراءه في الحياة والناس ، كبارا وصغارا ، وبعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم ، وبأحداث العصر التي تشغله وتدور من حوله . ويعتبر الكاتب عبد الله زكريا الأنصاري أن اللزوميات التي أبدعها المعري هي سجن رابع أدخل فيه نفسه بجانب سجونه الثلاثة المطبقة عليه ، وظل يرسف بهذه القيود ، وفي سجنه الرابع والذي تجلت فيه عبقريته اللغوية والأدبية والشعرية جاء بالكثير من المعاني وبالجميل من القول ، وبالرائع من الشعر والقصيد. بل إنه في سجنه هذ تفلسف وأمعن في فلسفته في الحياة وفي الناس .
ونحن لا نرى رأي الكاتب عبد الله الأنصاري ، فلا نعتبر اللزوميات سجن رابع ، بل نراه في الحقيقة جانب عبقري في شخصية أبي العلاء ، حيث يصنع لنفسه مساحات جديدة من الإبداع والحرية، وفضاءات أدبية رفيعة يتجلى فيها خياله ورؤاه ، ويجد فيها متسعا من الحركة الفكرية والنفسية ، حيث خذله حيز المكان ، وهو رهين ثلاثة محابس ، فاطلق لخياله العنان ، وساعدته ملكاته اللغوية والشعرية حيث كان متمكنا من آليات اللغة العربية وأدواتها العبقرية ، فأطلق لنفسه العنان ، ولعقله الحرية ، ولخياله ملكة الخلق والتشكيل.
وهناك من لا يستطيع فهم أبي العلاء المعري ، ويرون ان اللزوميات ، لزوم لا لزوم له ، ونقول ومعنا بعض الباحثين الجادين ، إن لزوميات أبي العلاء بالذات ، لزوم لها لزوم ، أعني أنها لزوميات لازمة ، لأنها مشحونة بطاقات من طاقات ابي العلاء التي لا حدود لها. وقد يعترض معترض فيقول إن لكل طاقة حدا محدودا ، نقول نعم ، لكن طاقة أبي العلاء لا حدود لها هي الطاقة التي خاض بها شتى مجالات الفكر ، لغة ، وتاريخا ، وعلوما ، وأدبا ، وجغرافية ،وفلسفة.
________
المراجع . .
* خيرالدين الزركلي (2002)، الأعلام (الطبعة الخامسة عشرة )، بيروت – لبنان: دار العلم للملايين، صفحة 157، الجزء الأول. بتصرّف.
*خالد البلوي (2013)، التقليد والتجديد في شعر أبي العلاء المعري، المملكة العربية السعودية: جامعة طيبة، صفحة 5-6، 24-31، 53-57. بتصرّف.

.png)


